|
أبصرت النور في 13 أيلول سنة 1927 في مدينة عكا بفلسطين
وتلقت دراستها الابتدائية في مدرسة الحكومة في عكا ثم في مدرسة الراهبات في
حيفا
وأتمت دراستها الابتدائية ومارست مهنة التدريس في مدرسة الروم الأرثوذكس من
عام 1943 حتى 1945.
ثم درست على نفسها اللغة الإنكليزية حتى أتقنتها وتابعت دراستها بالمراسلة
ورقيت في عملها وأصبحت مديرة المدرسة التي تعمل فيها.
وعندما وقعت النكبة عام 1948 انتقلت مع عائلتها إلى لبنان لفترة قصيرة ثم
سافرت إلى العراق وعملت في مجال التدريس في مدرسة للإناث بمدينة "الحلة"
لمدة عامين، عادت بعدها إلى لبنان وباشرت بالكتابة لبعض المجلات (الأديب
والآداب وغيرها).
وفي عام 1952 عملت بمحطة "الشرق الأدنى" للإذاعة العربية كمذيعة ومحررة
واستمرت في هذا العمل حتى عام 1956 وذاعت من إنتاجها الخاص ما يقرب من 300
حديث.
وفي عام 1957 تزوجت من أديب يوسف الحسن في بيروت قبل عيد الميلاد بيوم واحد
وعادت معه إلى بغداد
وهناك تعاقدت مع إذاعتي بغداد والكويت حيث شغلت منصب مراقبة للبرامج
الأدبية من عام 1957 حتى عام 1959،
كما شاركت في تحرير جريدة "الشعب" مع بدر شاكر السياب.
وفي أعقاب حوادث 1959 أُبعدت مع زوجها إلى لبنان وتعاقدت مع شركة "فرنكلين
للترجمة والنشر"
وقامت بترجمة طائفة من الأعمال الأدبية عن اللغة الإنكليزية.
وفي عام 1963 أعلن "أصدقاء الكتاب" في بيروت عن جوائز لأفضل كتاب قصصي
فاشتركت سميرة بالمسابقة ونالت جائزة القصة القصيرة على مجموعتها "الساعة
والإنسان".
وعندما افتتح المؤتمر الفلسطيني في 15 أيار عام 1965 وضمّ 2400 فلسطيني في
الشتات للبحث في قضية فلسطين
والتخطيط للعودة كانت سميرة من العضوات اللواتي حضرن المؤتمر وانتخبن
ليمثلن المرأة الفلسطينية فيه.
مؤلفاتها
1 ـ أشياء صغيرة ـ دار العلم للملايين بيروت 1954
2 ـ الظل الكبير ـ دار الشرق الجديد ـ بيروت 1956
3 ـ وقصص أخرى ـ دار الطليعة بيوت 1956
4 ـ الساعة والإنسان ـ المؤسسة الأهلية للطباعة ـ بيروت 1963
5 ـ العيد من النافذة الغربية- دار العودة – بيروت 1971
6
ـ
فصل من رواية "سيناء بلا حدود" مجلة الآداب ـ آذار 1964
7 ـ قصة "الحاج محمد باع حجته" مجلة الآداب ـ حزيران 1966
آثارها المترجمة
1 ـ جناح النساء ـ بيرل باك
2 ـ ريح الشرق وريح الغرب مؤسسة فرانكلين 1958
3 ـ كيف نساعد أبناءنا في المدرسة ـ مكتبة المعارف 1961 (ماري ولورنس
فرانك)
4 ـ القصة القصيرة ـ راي وست ـ دار صادر 1961
5 ـ القصة الأمريكية القصيرة ـ دانفورت روس ـ المكتبة الأهلية 1962
6 ـ توماس وولف ـ مختارات من فنه القصصي ـ دار مجلة شعر 1962
7 ـ أمريكي في أوروبا ـ دزوارت ـ المؤسسة الأهلية 1960
8 ـ حين فقدنا الرجاء ـ جون شتاينبك ـ دار الطليعة 1962
9 ـ حكايات الأبطال ـ اليس هزلتين ـ المؤسسة الأهلية 1963
10 ـ عصر البراءَة ـ أديث وارتون ـ المؤسسة الوطنية 1963
11 ـ فن التلفزيون كيف نكتب وكيف نخرج ـ وليم كوفمان ـ الدار الشرقية 1964
12 ـ رائد الثقافة العامة ـ كورنيلوس هيرسبرغ ـ دار الكتاب العربي 1963
13 ـ كانديدا مسرحية لجورج برناردشو ـ دار العلم للملايين 1955
14 ـ أعوام الجراد ـ لولا كريس اردمان ترجمة رباح الركابي ـ مراجعة ـ سميرة
عزام 1961
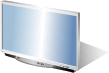
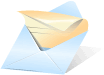
  



|
